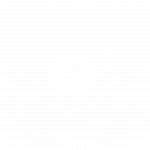بتول سويدان | محررة
بدأت الحرب الأهلية اللبنانية من بوسطة عين الرمانة، أو هكذا يحب البعض القول، متغاضين عن سنوات من السياسات والأحقاد التي انتهت باندلاع شرارة الحرب من البوسطة. على كلّ، فنحن اللبنانيون كثيرا ما نحبّ اختصار الأمور ببساطة والتغاضي عن المشاهد خلف الستار، وأحيانا أخرى يحلو لنا أن نصنع من “الحبّة قبّة”. والطبيعتان تجلبان لنا حيناً صبرا على واقعنا، وحينا آخر مشاكل لنا استعاضة عنها. على كلّ حال، بما أنّ استخدام البوسطة كلفظ للحرب من المشهور الشائع في وطننا، سأستخدم هذا المشهور اليوم للحديث عن بوسطة أخرى لأنقل وجهاً مختلفا للبنان، وجها لا يشبه الحرب الأهليّة.
أن أكتب مقالا كاملاً أصف به خط باص رقم ١٢ أمرٌ طريف بالنسبة إلي وسخيف بالنسبة لكثر آخرين. وقد أدرت مرارا أذني الصمّاء لطفلي الداخلي وهو يطالبني بالكتابة عن الباص الذي أستقلّه يوميّا للسنة الثالثة على التوالي. في فصلي الأخير في الجامعة قررت أخيرا الرضوخ لآمارات نفسي وكتابة هذه المقالة لتوديع أحد ملذات الحياة الجامعية: “كزدورة” الباص.
لا أكتب اليوم نصّاً وصفيّا في كزدورة الباص طبعاً، بل أكتب لأن تلك “الكزدورة” من الدوافع التي تقول لي: “انظري في البساطة ترين الجمال.” وإنّي أعلم عزيزي القارئ (ة) ما يدور في خلدك من أسئلة:” ماذا يرى الإنسان في باص عامّ أصلا؟!”
في الباص رأيت طالبة تقرأ القرآن في شهر رمضان لتستطيع ختمه في شهر واحد. رأيت أخرى تضع صليباً خشبيّا في عنقها ورأيت آخرين بلهجة الجبل ينزلون على جسر الكولا للتوجه الى الشوف وعاليه. رأيت السنة والشيعة والمسيحيين والدروز. ومن النافدة مررنا بالحمرا الى الكولا الى طريق جديدة الى الضاحية الجنوبية. في باص ١٢ جلسنا الى جانب عرب من سوريا وفلسطين ومصر وأجانب من أثيوبيا وبنغلادش.
في الباص رأيت كهلا يقرأ كتيّبا لفته في يد أحد الركّاب، تلامذة يتناقشون في صعوبة المواد، امرأة تشرح للسيدات من حولها كيفية اختيار باذنجان مميز لعمل المكدوس بعدما استقلت الحافلة بأكياس معبّئة بباذنجان صغير فاتح اللون. في الباص تشاجرت أختان على من سيدفع ثمن الرحلة عن الأخرى، ودخل علينا رجل غريب في عيد الأمّ ليوزّع عيدية على الأمهات. في الباص وزّعت علينا بطاقات تحمل رسم حنظلة وخريطة فلسطين بعد طوفان الأقصى وعلّق أحدهم علماً صغيرا خِيط بقطعة من كوفية على مرآة السائق. في الباص شرحت فتاة سورية كيف عانوا بسبب الحرب وشرح رجل لبناني معاناته بسبب الوضع الاقتصادي. في الباص عند المغرب سمعت السائق يتحدث مع راكب عربيّ عن أهميّة الوحدة العربيّة وبصوت واثق ينادي “آن لنا أن ننهي سايكس بيكو”. في الباص شابٌّ عشرينيّ لبق يتنحى جانبا كي يجلس سيدة مكانه وشابّة ثلاثينيّة مؤدبة تتنحى لتجلس كهلا أكل الشيب منه مأكلا.
في الباص أيضا رجل يتكلّم على جواله المحمول بصوت أشبه بالصراخ وآخرون يتابعون مسلسلاتهم عن الخيانة بصوت أعلى. في الباص فتاة بشعر طويل تصرخ بامرأة لأنها لمستها عن طريق الخطأ. في الباص طفل يأكل “قتلة أو عيطة” من والدته لأنه يتذمر وطالب هندسة يدخل علينا بمعداته التي لا تسع باصين منفردين له. في الباص أيضا عيون الواقفين الذين لم تسعهم المقاعد تتجسس على المحادثات الخاصة للجالسين أمامهم، وآذان الساكتين الفضوليين تدقق في حديث راكبين في المقعد المجاور لهم. في الباص شابّ أعرفه من الجامعة الأمريكيّة يتلفّت حوله خشية أن يراه أحد أصدقائه يستقلّ باصاً شعبيّا. في الباص كلّ شيء وكل أحد، صغيرٌ، كبيرٌ، مؤدبٌ لطيفٌ، أو عصبيٌّ صارخ. فيه الصالح والطالح. يقولون في لهجتنا الدارجة “عيش كتير، بتشوف كتير.” وأنا أقول استقلّ باص ١٢ بتشوف كتير.
في الباص لبنان بطوائفه المختلفة واللبنانيون بطباعهم المتنوعة. الحسنة منها والمكروهة. قد تكون بوسطة عين الرمّانة مثالا يضرب في التفكك والطائفية لكن آن الأوان ليتنحّى هذا المثال جانباً مفسحاً المجال للحديث عن أمثلة جميلة تنقل واقع اللبنانيين بعين أخرى. اللبنانيون المحبّون للحياة، المحبّون للآخر المختلف عنهم. اللبنانيون الذين مزّقتهم الحروب والأزمات والفساد لكنّهم ما زالوا في كل يوم يخرجون من بيوتهم يستقلّون باختلافاتهم باصاً واحدا الى جامعات وأشغال وورشات عمل لأنهم ببساطة يحبّون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا. هؤلاء المتسامحون مع الغير المتقبلون للبنان التنوّع همّ اللبنانيون الذين سنصفهم للعالم ونصدّرهم واجهة لنا، وأؤلئك الذين يقتاتون الضغينة سببا لوجودهم يمثلون أنفسهم ويمثلون تربيتهم المقيتة التي صنعتهم على هذه الهيئة.
أفارق تجربة الباص بعد إنهائي لدراستي الجامعيّة بكل هذه الطاقات المرحة والبسيطة التي ملأني بها اللبنانيون والعرب والأجانب وفي قلبي أمنية أن أرى ما أراه اليوم من اجتماع عربي في باص الوطن مجددا في حافلة كحافلة حيفا-بيروت التي أوقفها الاحتلال عن العمل بعد النكبة. لأنّها أيضا وبكل تأكيد تملك نفس روحيّة باص ١٢، روحيّة الجماعة والوحدة.