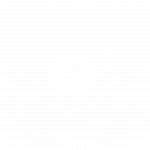علي عساف | محرر
في ليلة ظلماء، يمرّ شبح الموت ويجول في أزقّة الأحياء التعيسة جارًّا أذيال الأنفة المقيتة وراءه، يدور بين البيوت، يجتاز الجدران والأسوار الحديديّة، حتّى الأبواب الموصدة التي يجثو الناس خلفها خوفًا من العدوّ الخفيّ يخلعها. وبعد جولة سريعة، يحنو فوق عجوز قرّحت الدموع وجنتيْها، يداعب بيده اصفرار وجهها، يتأمّل ضعف إرادتها، فتتباطأ دقات قلبها، تتلفّظ بسملَةً لشهادة عسى ألّا تفوّتها، وقبل أن تختتم قراءتها، ينقدّ شبح الموت عليها ويعصر بكفّه عُصارة قلبها حتّى خطف الروح من جسدها. توارى بعدها إلى البعيد مُخلّفًا وراءه جثّة هامدة
نعم، إنّه الموت يطاردنا. عندما اعتمد ديكارت على الشكّ المطلق كمنهجيّة جديدة لغربلة ’الحقائق‘ المتداولة وانتقاء الصحيح منها غير القابل للشكّ توصّل إلى أنّ كلّ شيء زائف إلّا حقيقة أنّه يشكّ، فاستخلص عندها مقولته الشهيرة:” أنا أفكّر، إذًا أنا موجود.” وهذا يعني أنّ دليل وجوده مقترن بقدرته على التفكير والتشكيك. ولكن بعيدًا عن تكهّنات الأحلام والأوهام الديكارتيّة، لدى الوجوديين حقيقة مطلقة تندرج تحتها كلّ المسائل الوجوديّة. الحياة بعد الموت، الخلود، وجود الله، المسائل الدينيّة، جوهر الحياة، وغيرها أمور لا يمكن تأكيدها دون هامش من الشكّ ما عدا حقيقة مصيرنا المضمون والمشترك مع كلّ الكائنات الحيّة وهو الموت. فالموت حتميّ الحصول ولو كنّا نجهل توقيته أو أبعاده الوجوديّة. وبالرغم من أنّ موتنا حقيقة مؤكدة ندركها جميعًا، تبقى حيثيّاته مصدر قلق واضطراب نظرًا لتفوّق هذه الحقيقة على كلّ المعتقدات والتخيّلات، فالإنسان أو الفرد ميّال بطبعه للاستقلال بقراراته ومصيره وآماله. تحدّى الظواهر الطبيعيّة وحاول فهمها ليفرض سيطرته عليها، ما عادت العواصف والصواعق تثير الذعر في نفوس البشر كما كانت عليه سابقًا إذ طوّر العلوم وبات يتنبّأ حصولها قبل حصولها ويتجنّبها، إمّا عبر التحصين المسبق أو التحرّك السريع للتخفيف من آثار ظواهر طبيعيّة كانت تُعدّ سابقًا قوّة إلهيّة خارقة يعجز الإنسان أمامها. ولكن ما الحال إن كان الموت، بحتميّته، يحدّ آمال الإنسان بالخلود والاستمرار مهما علا بنفسه شأنًا وقوّةً؟
ماذا يمثّل لنا الموت؟
قد يُعرّف الوجوديّون الموت على أنّه فقدان الحياة أو خسارتها. فنحن نقدّر الحياة ونثمّن التجارب التي نخوضها فيها، الموت نهاية مشتركة بين كلّ الكائنات الحيّة ولكنّه وبالرغم من أنّه جزءٌ من دورة الحياة الطبيعيّة، يبقى عكس الطبيعة والحياة. لذلك، تولد المخلوقات كلّها وغريزة البقاء في صميمها تحاول أن ’تتفادى‘ (أو تُؤخّر) قدرها المحتّم. لذلك، فإنّ خوفنا من تجربة الممات أو عمليّة الاحتضار (process of dying) مشترك مع الحيوان نتيجة انشغال الغريزة بحماية المخلوق من الألم الجسدي المقترنِ بالممات وخطر الزوال. ولكن إذا قارنّا نظرة أو علاقة كلّ من الإنسان والحيوان مع الموت نجد اختلافًا صارخًا بينهما، فالإنسان مَعنيّ بوجوده وجوهره، وهذا يتمثّل بالتفكير المفرط والقلق تجاه الموت، الأمر الذي لا يخوضه الحيوان من الناحية الوجوديّة. أمّا السبب وراء ذلك فيعود حتمًا على قدرتنا بالتفكير (العقل) في التخطيط والتدبير وصولًا إلى ميزة بشريّة أساسيّة وهي اتخاذ القرار والاختيار. فالحياة لا قيمة لها دون هذه الحرّيّة والقدرة على تحديد المصير لأنّ هذه الخاصيّة هي التي تميّزنا عن الحيوان. عندها وجب القول إنّ الموت ليس بانعدام الحياة، إنّما بفقدان حرية الاختيار والتقرير، ممّا يجرّدنا من قيمتنا الإنسانيّة أي وجودنا وهويّتنا.
الموت والقلق الوجودي
الموت يشكّل تحدّيًا للإنسان وقدرته على تحديد المصير، لذلك نلحظ علاقة متوتّرة متضاربة بين الإنسان والموت. الإنسان بحرّيته مصمّم على تحقيق كلّ ما يسعى إليه دون أن يفوّت قطار الحياة قبل تنفيذه، وبما أنّ عمر الإنسان محدود وضيّق أمام اتساع أحلامه، يسعى لاستغلال كلّ الفرص واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وبما أنّه أمام خيارات لانهائيّة، يرى سارتر أنّه من الصعب اختيار الأنسب دون هامش من الشكّ والتردّد، خصوصًا وأنّ الإنسان مسؤول أمام قراراته التيّ قد تتوسّع انعكاساتها لتشمل العالم كلّه، وليس هتلر وجرائمه إلّا خير دليل على ذلك. من هنا ينبع القلق الوجودي الهائم عبثًا بين جوقة خيارات مصيريّة، فالموت مدعاة للقلق الدائم تجاه صحّة خطواتنا على الصعيد الشخصي والمجتميّ. ونتيجة لهذا التوتر والضياع، تتعدّد نظرة الناس إلى الموت، فإمّا أن يتبنّوا حياة أصيلة أو غير أصيلة، ولكلّ منها خصائصها.
الأصالة: نجمٌ خافتٌ في ليل دامس
النفس البشريّة ميّالة (نظريّا) للأصالة في علاقتها مع الموت لأنّ ذلك أسمى الحالات الوجوديّة التي تكون بها النفس منسجمةً أو متصالحةً مع الموت. يرى هايدغر أنّ الإنسان يعيش حياةً أصيلة إذا حقّق “استعدادًا استباقيّا” ((anticipatory resoluteness لتقبّل الموت متى يحلّ، عندها نتخلّص من القلق الوجودي وننأى بانفتاحٍ تجاه كلّ تقلّبات الحياة. بالرغم من رغبتنا لهذه المرحلة، نرى النفس تتعثّر أبدًا للوقوع في اللاأصالة لأنّ هذه الحالة أكثر اطمئنان وثبات واستقرار ممّا سبق ذكره. اللاأصالة كناية عن تخدير لأسئلتنا الوجوديّة عبر التناسي أو غضّ النظر عنها من خلال انغماس النفس باليوميّات (everydayness) وما يتخلّلها من أحاديث وممارسات لتبديد الوقت. نتعاطى مع الموت وكأنّه سيحصل في المستقبل البعيد، لا في أيّ لحظة، وبأنّه سيصيب الجميع إلّا نحن. يموت أحد الأقارب ونحوّل الحدث إلى عزاء (ملتقى اجتماعي)، نرثي الميّت، يتوارى الثرى، ثمّ كلّ إلى عمله وحياته الخاصّة. نرسم لأنفسنا هدفًا (بعد أن يَخطّه المجتمع): تاجرًا، مُعلّمًا، مهندسًا، مديرًا، … نغوص في بحره دون أن ندرك أنفسنا، وتتلاشى هويّتنا. ما هو جوهر وجودنا؟ ما الذي يميّزنا عن القطيع؟ ماذا بعد الموت؟ ما سرّ الوجود؟ وأين لنا من العدل الإلهيّ المنشود؟ كلّها أسئلة ينساها العقل في ظلّ الضوضاء الناتجة عن حركة البشر. ولكن هنا يظهر التناقض في الطبيعة الوجوديّة لدى الإنسان: النفس ميّالة للأصالة، تنصبها قبلة تتطلّع إليها، إنّها الحالة الأرقى والأسمى في الوجود، ولكنّها في الوقت نفسه تندفع نحو اللاأصالة لاإراديّا لأنّ هذه الحالة تثير الفضول الوجودي في استكشاف العالم الماديّ الذي يحجب الأسئلة الوجوديّة ويمنح الراحة. ولكنّ اللاأصالة، التي تبدو مريحة وغير مُقلقة، لا تدوم نظرًا لتأنيب الضمير والشعور بالذنب الوجوديّ الذي ينتاب الفرد، فالنفس تشعر بالغربة في اللاأصالة، على عكس ما يظهر عليها من رحابة وانتماء لها. عندها، تحاول النفس الغارقة في اللاأصالة أن تطفو وتتحرّر من أشباكها. وبين جزر اللاأصالة ومدّ الأصالة تضيع النفس البشريّة في دوّامة من القوى المتضاربة، وهنا ندخل في الأزمة الوجوديّة وتظهر المشاكل النفسيّة. إختصارًا، استنادًا على نظريّة الفرويد، يمكننا تشبيه النفس بالأنا المتأرجحة بين اللاأصالة (الهو) والأصالة (الأنا الأعلى).
الأديان في خدمة اللاأصالة
وبما أنّ اللاأصالة راحةً للنفوس من قلق الوجود وعتق الأسئلة المعلّقة حتّى إشعارٍ آخر، نتتبّع دور الأديان في سدّ تطلّعنا الوجوديّ نحو المجهول. مسألة الأديان مسألة في غاية التشعّب والتعقيد لدى الوجوديّين، بدءًا بمسألة الإيمان وعبثيّة البرهان العلميّ المحايد عند كيركغارد، وصولًا إلى نقد المسائل والروايات الدينيّة التي تتعارض مع القيم الإنسانيّة والصفات الإلهية ممّا يضع علامات استفهام حول مصداقيّة الأديان وحقيقتها. ولكنّنا سنتناول بعض الأجوبة المقترحة للأسئلة الوجوديّة. بالرغم من تعقيدها، يكون الجواب مختصَرًا حاضرًا قائمًا بذاته مُنزّلًا من عدمٍ، والجواب، لا شكّ: الله. هو صاحب الجلالة الموجود والمسؤول عن زماننا ومكاننا ومصيرنا وجوهرنا، فلا داعي للتفكير ونحن محدودو التفكير. يصدّق الإنسان غير الأصيل ما قُدّمَ إليه من أجوبة على طبق من فضّة دون التشكيك أو الاستفسار عن صحّتها ومنطقها، بينما يسترسل الإنسان الأصيل في البحث والتحري عسى أن يستوي على معتقد، ويجب الإشارة إلى أنّ الوجوديّين لا يربطون اللاأصالة بالدين وصمةَ عارٍ بحقّه، فقد يعيش المؤمن حياةً أصيلة كما هي الحال مع كيركيغارد الملقّب بأب الفلسفة الوجوديّة، فهو مؤمن بالمسيحيّة وأيضًا أصيل كونه ناقش مسألة الإيمان وعارض الكنيسة بنهجها المعتمد في قانونها الكنسيّ الانتقائيّ. لذلك، فإنّ بوّابة اللاأصالة هي مبدأ التسليم بالأمور.
الموت حقيقة مرّة، على الإنسان تقبّلها بجوهرها فعلًا وقولًا، فالارتقاء إلى الأصالة ليس بالأمر السهل إذ يتطلّب مصالحة الموت وتقبّل عشوائيّة حصوله لنا في أيّ لحظة. التخطيط المستقبليّ مهمّ وضروريّ لتحقيق المُراد، ولكن فلنعترف أنّ الحاضر وحده هو المضمون، وأنّنا إن أمعنّا التفكير بالمستقبل على حساب الحاضر فإنّنا نجازف بحياتنا وندفعها للاستسلام لعشوائيّة التوقيت المحتّم بحيث نتلاشى مع الوقت ونفقد وجودنا وجوهرنا. قد لا نتوصّل إلى أجوبة مؤكّدة تروي تعطّشنا للمعرفة الوجوديّة، ولكن، في جلبة البحث والتحرّي والاستقصاء لا بدّ أن نجد أنفسنا بأنفسنا كي لا نموت وفي أنفسنا شيء من الفراغ الأعمى…