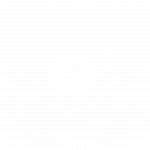باسم الحرفاني | محرر
:نبذة عن حياته
ابن عربيّ، هو محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبدالله الطائي الحاتمي. وُلِد في مدينة مرسيه (جنوبي شرقي الاندلس) في 17 رمضان من عام 560ه الواقع في 28 تموز 1165م، في بيت علم وفضيلة. في طريق حصيله العلمي لقي الفيلسوف ابن رشد. ثم انضم إلى الحلقات الصوفية، وسلك الطريق وليس الخرقة. وكان شيخه ابن مسرّة الفيلسوف الأندلسي القرطبي. وفي سن الثلاثين ذهب إلى تونس بعد أن زار سبتة وغرناطة، وأهم مدن الغرب
رحل إلى المشرق حاجًّا”، ثم زار بغداد ومصر والأسكندرية، ومنها عاد إلى مكة ثم إلى حلب، وأخيرًا استقر في دمشق حيث توفي فيها ودفن في سفح جبل قاسيون في الحي المعروف اليوم باسم الصالحية، ومقامه هنالك مزار عظيم. وقد شاهد ابن عربي الحروب الصليبية، وكان يحرّض المسلمين عليها.
:أبرز مؤلفاته-
.الفتوحات المكية جمع فيه العلوم الصوفية أو علوم الدين ومعالجة من ناحيتها عليها-
.فصوص الحكم وفيه خلاصة مذهب ابن عربي في نظرية وحدة الوجود الاتحاد-
.مشكاة الأنوار فيما روي عن الله عزّ وجلّ من الاخبار-
الإشكاليّة: فما هي نظرة ابن عربيّ إلى الوجود والإنسان الكامل؟ وهل يتعارض تصوف ابن عربي مع الفلسفة؟ أم يتوافق معها؟ وما مدى تأثيره في النّهضة الأوروبّيّة؟
:تصوفه-
تصوف ابن عربيّ ليس زهدا” ولا تقشفًا، بل يرمي إلى إثبات شخصية الإنسان في الوجود الإلهي. فهو يعتبر هذا العالم المختلف في أشكاله مظاهر متعدّدة لحقيقة واحدة، هي الوجود الإلهي. فالمعرفة الصوفية لا تُدرك عن طريق العقل، بل هي معرفة ذوقية، هي نوع من الإلهام، يهبه الله إلى خاصيته.
إن غاية الحياة الصوفية هي الوصول إلى مقام المعرفة، الذي فيه تتجلّى الحقائق، فيدركها الصوفي إدراكًا ذوقيًّا، “إنه بمقدار ما يعرف العابد من ربّه يكون إنكاره لنفسه.”. فهو يرى أن الوجود في جوهره واحد، وأنّ الموجود حقيقة هو الله، فالله هو عين الموجودات: فالمستحدثات ليست إلا هو وانّ الحق (اي الله) المنزه هو الخلق (اي العالم) المشبه. فالعالم ظل الله، فكل ما ندركه هو، وجود الحق في اعيان الممكنات، فمن حيث أحدية كونه ظلًّا هو الحق، لأنه الواحد الأحد، ومن حيث كثرة الصور، هو العالم. فإذن ليس للعالم وجود حقيقي، بل الله هو عين الأشياء كلها وعين الوجود، ولذلك كان حفظه لصورته حتى لا تكون يلك الاشياء غير صورته، اذ العالم صورته وهو الكون كله.
الخلق لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الحق، والحق لا يمكن أن يتجلى إلا إذا هو أوجد الخلق، والوجود المزدوج من الحق والخلق يشكّل وحدة فيستحيل علينا أن نرى الخلق (العالم) من غير أن نرى الحق (الله) متجليًا في كل جزء من أجزائه.
:وحدة الوجود-
تعتقد فرقة هامة من الفرق الصوفية أنّ الحقيقة الوجودية واحدة، وأنّ الكثره هو الظاهر و الحق هو الباطن، ويُعرف أهل هذه الفرق بأصحاب وحدة الوجود والقائلين بالاتحاد والذات الإلهية بما هي ذات لا يمكن معرفتها. لذا يجب أن نعلمها عن طريق أسمائها وصفاتها، وهي جوهر له غرضان: الأول: الأزل والثاني: الأبد. وله نعتان الأول القدم، والثاني الحدوث. وله اسمان الاول الرب والثاني العبد. وله وجهان الأول الظاهر وهو الدنيا والثاني الباطن وهو الآخرة.
فالوجود المحض إذًا من حيث هو كذلك ليس له اسم ولا وصف، والحقيقة أنّ الذات عين الصفات وليست شيئًا غيرها، كالماء الذي هو عين الثلج وليس شيئًا غيرها.
والله اذ يتجلى في كل مخلوق ببعض صفاته على قدر استعداد ذلك المخلوق، يتجلى في الإنسان بجميع الصفات. لأنّ الإنسان هو العالم الأصغر وفيه يتجلى العقل ذاته بجميع صفاته. ومعنى هذا، أنّ الحق بعدما تحقق وجوده الكامل في النشأة الإنسانية رجع إلى نفسه بواسطة هذه النشأة، أو على حدّ التعبير الصوفي أصبح الحق والخلق عينًا واحدة في صورة الإنسان الكامل الذي هو النبي أو الولي. فالإنسان الكامل يجمع بين الحق والخلق. فالحركة الصعودية للحق من عالم الظاهر إلى عالم الذات تتم في حالة الشعور بالاتحاد الذي يشعر به الصوفي. أما الحق فإنه يُدرك من طريقته: طريقة المعتقدات، وذلك أنه لا بدّ لكل شخص من عقيدة في ربه يرجع بها إليه ويطلبه فيها. ” فاذا تجلى له الحق فيها عرفه واقرّ به وإن تجلى له في غيرها أنكره وتعوّذ منه ما ساء الادب” . فالمعتقدات هي من صنع خيال البشر ويمكن أن يوضع له تعريف، وصاحبه جاهل بحقيقة الألوهية.
أما الطريق الصحيح لمعرفة الحق فهو مذهب وحدة الوجود القائل بانّ هذا الخلق هو صورة الحق. هذا هو الإله المطلق الذي يعرف في كل صورة وفي كل معتقد. فلا يسعه شيء لأنه هو عين الأشياء، وعين نفسه أيضًا. وطريق الخلق إلى الحق هو طريق الحب الإلهي، أعني حب الله لنا وحبنا لله، أما حب الله لنا فقد صرّح الله به عندما قال: “إنّ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين… إنّ الله يحب المحسنين… إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص” . وقال تعالى أيضًا: ” إنّ الله لا يحب المعتدين… والله لا يحب كلّ كافر به… فإنّ الله لا يحبّ الكافرين… والله لا يحبّ الظالمين… والله لا يحب المفسدين” ، ويستشهد ابن عربي خصوصًا بآيتين:
“قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله”…”فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه”
أما حبه لله فيقول: ولقد بلغ بي قوة الخيال أن كان حبّي يجسّد لي محبوبي من خارج عيني، فلا أقدر أن أنظر إليه ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه. ولقد تركني أيامًا، لا أسيغ طعامًا، كلما قدمت لي المائدة يقف على طرفها وينظر إليّ ويقول بلسان اسمه: أتأكل وأنت تشاهدني؟ فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعًا، وأمتلي منه حتى سمنت وثملت من نظري إليه. فقام لي مقام الغذاء. وكان أصحابي وأهل بيتي يتعجبون من سمني على عدم الغذاء لأني كنت أبقي لأيام كثيرة لا أذوق ذوقًا، ولا أجد جوعًا ولا عطشًا، لكنه كان لا يبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحركتي وسكوني” .
ولما كان الخلق انعكاسًا للحق فمن أحبّ الخلق أحبّ الحق. والخلق في غاية الإحكام والإتقان، إذ إنه صورة الله. وهكذا أنهى ابن عربي التوحيد المطلق إلى وحدة الوجود وإلى الاتحاد والغناء في الحق. وكما قال ابن عربي بوجود واحد حقيقي هو: الله، كذلك قال بمعبود واحد حقيقي هو الله. فمهما عبد الإنسان، فهو إنما يعبد الله من وراء حجب هذه المصورات، لأنه عبدها وهو يعتقد أنها الله، فالله كان مقصوده.
ويستدل ابن عربي على رؤيته هذه بالآية الكريمة: “وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه” . وتأسيسًا على هذه الرؤية، لم يعد ينكر الآخر، وفاضت محبته الشاملة لجنس البشر من ينبوع “دين الحب”.. يقول شعرًا
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه دان
وقد صار قلبي قابلًا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني
:بين التصوف والفلسفة-
عندما التقى ابن عربي في مطلع شبابه بابن رشد سأله ابن رشد: “هل القمة التي وصل إليها المتصوفة الفلاسفة بالعقل والفكر, هي القمة التي وصل إليها المتصوفة بالتصفية والتجرد والذكر؟” فقال محيي الدين: “نعم ولا” لأن العقل يمكن أن يهدي إلى معرفة الله من خلال التفكر في أسرار الكون وعجائبه، فهذا الكون الكامل المنظم بدقة متناهية لابد له من خالق “وأنّ في خلق السموات والأرض لآيات لقوم يعقلون” بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا العقل الذي وصل إلى تلك القمة أن ينزلق ويقع في المتشابهات ويُضِل عن فهم الذات الإلهية، ناهيك عن ابتعاده عن التعبد وتحلله من القيود الشرعية. أو كما يقول ابن عربي في حديثه عن ابن رشد: “كان بيننا حجاب رقيق، فكنت أراه ولا يراني”
فلا جدال في ان الفلسفة قد توصلت الى معارف إنسانية وعلوم نظرية ووثبت فيها وثبات لها اثرها في الفكر الإنساني لكنها بقيت عاجزة عن معرفة الأمور الإلهية، لان ما وراء الطبيعة هي فوق مدارك العقل, ولا امانة الا لطريق الوحي والالهام لذلك قال ابن عربي: “بين نعم ولا تطير الأرواح.”
وإذا كانت الفلسفة هي الطريق المؤدية الى معرفة الذات الإلهية والغرض منها اصلاح النفس بان تستعمل في دنياها الفضائل والسيرة الحسنة التي تؤدي إلى سلامتها يوم الميعاد، وكان التصوف هو معرفة الصانع بما له من صفات الكمال والتنزه عن النقصان في النشأة الأولى والآخرة ومعرفة المبدأ والميعاد فإننا نرى أن طريق التصوف يلتقي مع طريق الفلسفة من حيث النظر والاستدلال أو الرياضة والمجاهدات فإذا تكلموا الأولى فهم الحكماء المشاؤون (الفلسفة الأفلاطونية) وإن تحدثوا في الطريقة الثانية فهم الصوفيون.
إذا” فالفلسفة تؤيد التصوف في أن التصفية والتجدّد والتطهر يكسب الروح إشراقا” تصل إلى المعارف كلّها، يقول ابن عربي: “اعلم أن الفلسفة ما ذمت لمجرد ذلك الاسم، وإنما هو لما أخطأوا (أي الفلاسفة) فيه العلم المتعلق بالإلهيات، فان معنى الفيلسوف المحب للحكمة، والحكمة غاية كل عاقل.” لذلك يرى ابن عربي أن ما سلم من علوم الفلسفة هو ميراث لكل صوفي، فالفلسفة الحقّة غايتها الحكمة، والحكمة ضالة كل مؤمن. ويقول غوستاف لوبون: “آخر ما وصلت إليه الفلسفة أنه لا قدرة للعقل حتى الآن على فهم أسرار العالم.”
– أثر محيي الدين في النهضة الأوروبية
يقول كلود فاريرا، أحد مؤرخي فرنسا وأدبائها:” إن هزيمة العرب في بواتيه، قد أخَّرتِ المدينة الغربية ثمانية قرون..
لقد كانت المعاهد العلمية الإسلامية في الأندلس، هي المنارات التي ترسل الهدى والنور إلى أرجاء أوروبا، وهي المناهل العذبة التي هرع إليها رجال الطليعة الأوروبية، ليتزودوا من معارفها ويقتبسوا من نورها، ثم يعودوا إلى بلادهم مبشرين ومنذرين وداعين إلى العلم والفكر الإسلامي.
يقول «جونس» المؤرخ المعاصر لفولتير: لقد كانت تعاليم ابن رشد هي الراية التي يتقاتل حولها الأحرار من رجال الفكر الأوروبي، وكانت كتب الرازي وابن سينا هي القمم العالية في معاهد الطب ومدارس العلم في إيطاليا وفرنسا. بل أعظم من هذا في الدلالة وأعجب: أن النهضة الدينية نفسها في أوروبا، تدين لمسلمي الأندلس عامة، ومتصوفة الأندلس خاصة، بالبعث والحياة.
لقد كانت المعارف الدينية في أوروبا طلاسم وأحجية وأسرارًا، تظللها أردية الرهبان المقدسة، وتحتكرها طوائفهم أصحاب القسوة العالمية، معارف مظللة لا تقبل جدلًا ولا حوارًا، ولا تطيق علمًا، ولا ترضى منطقًا، بل تُسَخِّر كل ما ترى لأهوائها ونزواتها، متعالية مترفعة لا تعلل ولا ترضى أن يسألها إنسان عَمَّا تفعل.
ثم نظرت أوروبا بعين الإجلال والدهشة إلى المعارف الدينية الإسلامية في الأندلس، وهي ثروة مباحة لكل قاصد، ومنهل يتدفق لكل راغب، وساحة للآراء، ومنتدى للمناطقة، ومجالًا لكل صوَّال وقوَّال؛ فلا أسرار ولا أقنعة، ولا لاهوت مخبوء تحت أردية الكهان والرهبان، محاط بالأسرار والظلمات، بل معارف وعلوم تساهم في أحداث الحياة، وتشرح مواقف العقول ومعضلات الفكر، وتلين لكل مجتهد، وتفتح صدرها لكل متفنن مبتكر، وتهب نورها بالقسط لكل مؤمن.
نظرت أوروبا إلى تلك الحرية الهائلة، التي يتمتع بها العرب في النظر إلى الدين الإسلامي، وإلى تلك القوة الهائلة المتفجرة من ينابيع الهدي المحمدي؛ فأقبلتْ عليه تسترشد وتتزود، ثم تعيد نظرها في لاهوتها المسيحي؛ محاولة أن تنفخ فيه الحياة وأن تلقحه بالمنعشات، وأن تمسه بسحر الحرية، وأن تنقله من أبراجه إلى الأفق العام؛ ليكون آية للناس كافة، لا حماية للقسس والرهبان فحسب.
يقول الأستاذ العقاد في كتابه «أثر العرب في الحضارة الأوروبية»: “إن الفلسفة الصوفية الإسلامية هي الطريق التي ظهر منها ما ظهر من آثار التفكير الجديد في العالم المسيحي، وفي العقائد الأوروبية على الإجمال، ونظرة واحدة إلى أرقام السنين التي ازدهر فيها اللاهوت المسيحي، ونجحت فيها دعوة الإصلاح الديني، ترينا أن ذلك لم يحدث قبل احتكاك أوروبا بالحضارة الإسلامية في الأندلس”.
ويشير العلامة «نيكولسون» في مجموعة تراث الإسلام إلى المشابهات بين أقوال الصوفية المسلمين، وأقوال الصوفية الأوروبيين من الأقدمين مثل: إكهارت الألماني، والمحدَثين مثل: إدوارد كاربنتر الإنجليزي، ثم يقول: ” إن النهضة الأوروبية لم تظهر لها علامة واحدة قبل الاحتكاك بينهم وبين المسلمين، فإن دروس العرب في جامعات الأندلس حضرها رجال الدين والدنيا في سائر أنحاء أوروبا”.
تلك شهادة كاتب أوروبي معاصر، صريحة في أن النهضة الأوروبية لم تظهر لها علامة واحدة قبل الاحتكاك بينهم وبين المسلمين، وصريحة أيضًا في أن دروس العرب في جامعات الأندلس قد حضرها رجال الدين والدنيا في سائر أنحاء أوروبا، ثم انقلبوا إلى شعوبهم مبشرين وداعين إلى العلم الجديد المشرق في سموات الأندلس.
ثم يواصل «نيكولسون» بحثه في أثر الأندلس في البعث الأوروبي فيقول: «إن ابن عربي عبقري الإسلام في الأندلس، بدراساته الجريئة في الإلهيات، ومشاهداته الكبرى في عالم الروح، قد عَبَّدَ السبل أمام اللاهوت المسيحي للنهوض والتحلل من القيود.» ثم يقول: «وأثر ابن عربي في النهضة الأوروبية لم يقتصر على هذا، بل له آثاره في بعث الأدب الأوروبي أيضًا، فإذا قابلنا بين ما كتبه دانتي مثلًا حينما نظم الكوميديا الإلهية وبين ما كتبه ابن عربي، نرى أن دانتي قد تتلمذ على ابن عربي تلمذة واضحة في النهج والأسلوب والطريقة، بل وفي الصور والأمثال والاصطلاحات والأساليب الفنية.»
وليس «نيكولسون» وحده هو الذي يقول هذا، بل نرى أيضًا المستشرق الكبير «آسين بلاسيوس الإسباني» يشهد بأن نزعات دانتي الصوفية في كتبه، وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من ابن عربي بغير تصرف كبير، ثم يقول بعد ذلك: «إن ابن عربي هو الأستاذ الحقيقي للنهضة الصوفية الدينية في أوروبا.» ولنستمع إليه إذ يحدثنا قائلًا: «ومن المعلوم: أن أول الفلاسفة الصوفيين من الغربيين وهو «جوهان إكهارت الألماني» قد نشأ في القرن التالي لعصر ابن عربي، ودرس في جامعة باريس، هي الجامعة التي كانت تعتمد على الثقافة الأندلسية في الحكمة والعلوم، وإكهارت يقول كما يقول ابن عربي بأن الله هو الوجود الحق، لا موجود على الحقيقة سواه، وأن الحقيقة الإلهية تتجلى في جميع الأشياء، ولا سيما روح الإنسان التي سعادتها الكبرى في الاتصال بالله عن طريق الرياضة والمعرفة، والتسبيح والتحميد، وأن صلة الروح بالله، ألزم من صلة المادة بالصورة، والأجزاء بالكل، والأعضاء بالأجسام.
ومن هذه الفلسفة قبسات واضحة في مذهب «سبينوزا»، الذي نشأ في هولندا، وأصله من يهود البرتغال، الذين أُكرهوا على الدين المسيحي، فقد كان كلامه عن الذات والصفات، وتجلي الخالق في مخلوقاته، وتلقي الخلق نور المعرفة الصحيحة بالبصيرة والإلهام، نسخة من فلسفة ابن عربي.
والفيلسوف المتصوف الإسباني «رايمو ندلول» قد اقتبس معارفه عن أسماء الله — تعالى — وأثرها في الكون، من كتاب ابن عربي: «أسماء الله الحسنى». وكان رايموند يحسن العربية، وعاش بعد ابن عربي، فانتحل الكثير من تراثه، وراح يزود المكتبة الأوروبية بالروائع التي تدل معانيها في وضوح وجلاء على صحة أبوة محيي الدين لها؛ لاسيما وهذا اللون من العلوم لم تعرفه من قبل الديانة المسيحية.»
ولسنا هنا نتصيد الدلالات على أثر محيي الدين في النهضة الأوروبية الحديثة بشقيها الديني والأدبي، فكتب التاريخ الأوروبي عامة، وكتب رجال الاستشراق خاصة، تشهد بأن ابن عربي الفيلسوف الصوفي — كما يسمونه — كان له أكبر الأثر في عقول النساك ورجال الإصلاح الديني والمتصوفة من فقهاء المسيحية الذين ظهروا بعده، بل إن مذهبه العالمي في المحبة الذي يمثله قوله
أَدِينُ بدِين الحب أَنَّى توجَّهتْ
ركائبُه فالحب ديني وإيماني
.قد اتخذه فقهاء المسيحية، بل ورجال الإصلاح فيها لهم شعارًا ودثارًا
ولقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن أثر ابن عربي في الإصلاح الديني في اللاهوت المسيحي، لا يقل عن أثر مارتن لوثر نفسه، أو على الأقل هو الذي مهد له الطريق، وأنار الجادة بهتافه الحار للحرية الفكرية، والحرية العلمية في تناول المعرفة، وبدعوته إلى الاجتهاد، وفتح بابه للناس كافة، وعدم تقديس الآراء السابقة، بل وعدم التقيد بقيودها؛ ما دامت قد صدرت عن عقول بشرية، لا من حقائق إلهية.
كما كان له أكبر الأثر في الأدباء الربانيين، من أمثال دانتي وغيره، حتى ليقول المستشرق «آسين» الإسباني: ” إن أوصاف الجنة والنار، والعروج إلى السماء، والأقباس الروحية، والنشوة القلبية في الأدب الأوروبي الحديث، كلها تستمد أصولها الأولى من ابن عربي وفلسفته الكبرى، التي نشرت أجنحتها الفضية قرونًا على الأفق الغربي”.
ذلك بعض ما يُقال في أثر محيي الدين في النهضة الأوروبية، وذلك بعض ما يقوله أئمة القلم في أوروبا عن محيي الدين، وعن فلسفته الكبرى التي نشرت أجنحتها الفضية قرونًا على الأفق الغربي