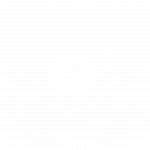علي زهرالدين | محرر
بينما كنت تبحثُ عن فرصة عمل في إحدى دول هذا العالم، حطّت سفينتك على ساحل هادئ. إنّها دولة ذات مختبرات علمية ومراكز أبحاث تكنولوجية وشركات كبرى معروفة عالميًّا. أمّا جامعاتها، فهي عريقة. وفي الجانب الأدبي والإنساني، تجد مراكز البحوث والاستشارات السياسية، وترى الحيويّة في مجالات الفلسفة والاجتماع واللغات. مما لا شك فيه أنّه مشهد بلد ناجح، مقتدر، مستقرّ، يوفّر عوامل الرفاه الاجتماعي المادّي والمعنوي…
لعلّك ظننت أنّ هذه الدولة هي الولايات المتحدة، أو ألمانيا. ولكن، لماذا ننسى أنفسنا، أين نحن من مشهدٍ كهذا؟ ألا يستحق هذا المشهد أن نقف عنده ولو بضع دقائق لنسأل أنفسنا بجرأة: أين نحن، لماذا لا نكون هكذا؟ ما هو واجبنا فعلًا تجاه الوطن؟ كلنا نقول بأننا وطنيون. ولكن أمام سؤال كهذا، وغيره كثير، ما هو جوابنا؟
كي نصل ببلدنا إلى هذا الساحل الهادئ، وتستقرّ سفينتنا في هذا الشاطئ، وهي بلا شك الآن في وسط عاصفة وأمواج عاتية. نعم، البحر ليس هادئًا. ولكنّ السؤال الأهم: أين السفينة؟ وأين يقع ذلك الساحل السحري؟ عندما نعرف ذلك، تتضح لنا معالم الطريق..
منذ أن بدأنا الدراسة في الجامعة، نربط كل ما نتعلّمه بالوصول إلى الشركات الأجنبية الكبرى، كأنها الغاية الوحيدة، وكأنّنا في سجن ننتظر فرصة الخروج منه. لماذا لا يكون الهدف تطوير بلدنا وإحداث نهضة علمية وفكرية حقيقية؟ لماذا لا نبذل جهدنا لنترك أثرًا في الإصلاح، وتحقيق العدالة، ومكافحة الفقر؟ ما معنى أن نجمع المال خارج البلد ثم نعود لنصرفه أيام العطل؟ نحن لسنا فقط نقبل بأن يكون بلدنا بلدًا سياحيًا حصرًا، بل نغذّي هذا الفكر ونرسّخه. لا يمكن أن نقول إننا سنعود عندما تتحسّن الأوضاع؛ فمن سيحسّنها؟ ومن يحمل هذا الهم؟ لا شكّ أنّ هذه مسؤوليتنا جميعًا، وقد أثبتت مبادرات شبابية عديدة أنّ التغيير ممكن وأنّ لها أثرًا علميًا وعمليًا واضحًا.
أغلب الشباب المتفوّقين أكاديميًا يطمحون للعمل في غوغل أو ميتا. نعم، هناك تطوّر مهني وراحة مادية، وينظرون بعين العقل إلى كل نصيحة تقودهم إلى تلك الشركات أو إلى مراكز أبحاث خارج بلدهم. لا ألومهم؛ فبعضهم منهك من واقع البلد، وبعضهم يسعى إلى العيش الكريم، وبعضهم يطلب علمًا ينوي أن ينفع به وطنه. لكن، ألا تقع على عاتقهم مسؤولية تجاه بلدهم، وتجاه المشكلات التي دفعتهم أصلًا إلى الاغتراب؟ أليس الأولى أن نسعى لوقف النزيف وفقدان رأس المال البشري في لبنان، حتى لو استلزم ذلك تضحيات شخصية؟
صحيح أنّ الشباب ليسوا مسؤولين عن أزمات البلد، لكن من سيغيّر هذا الواقع؟ هل ننتظر الأجيال السابقة؟ ماذا عنّا نحن؟ وماذا عن المتميّزين أكاديميًا المنتشرين في الجامعات والشركات العالمية؟ أليس لديهم من الخبرات والمعرفة ما يكفي لمعالجة مشكلات بلدهم؟ أليس لديهم حلول مبتكرة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات، والتعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية؟ إنّ لبنان يملك أدمغة لامعة موزّعة في أنحاء العالم، ولو عاد بعضها، لساهم في إنقاذ البلد من أزمات خانقة.
يجب أن تسقط كل الذرائع، وأن نلغي اليأس من قاموسنا. يجب أن نرمي كل ذلك عن ظهرنا، كي تصبح الحمولة أخف، فتسهُل حركة السفينة علينا جميعًا. علينا أن نراجع رؤيتنا للعلم: لماذا نربطه فقط بالنجاح المادي؟ لماذا لا نراه نورًا ووسيلة للنهوض بالبلد من تحت الركام ليصبح مقتدرًا بحق, لنحقق قيم العدالة ونقضي على الفقر؟ ومن قال إنّ النجاح محصور بالوصول إلى تلك الشركات والجامعات؟ أليس الكادح في وطنه، الذي يبني وعيًا ويعلّم وينفع بعلمه، ناجحًا أيضًا؟
خلاصة الكلام، إنّ هجرة الأدمغة ظاهرة تعاني منها الكثير من الدول، ولكن بعض هذه الدول متقدمة، وقد يكون لديها فائض أدمغة في الداخل. أمّا نحن، فبلدنا بحاجة ماسة إلينا وهو ينادينا باستمرار. ليس لدينا فائض علماء محليين لنعلّق عليهم آمالنا ثم يذهبوا إلى بلاد أخرى، بل على العكس تمامًا. لدينا موارد ويجب تسخيرها لحل مشاكل بلدنا العزيز. علينا أن نعقد النية ونحسم الخيار بأنّه يجب على هذه السفينة أن ترسو في شاطئ واحد, شاطئ التقدم والاقتدار والمعرفة. على كلّ منا أن يسأل نفسه: ما هي المشاكل التي أراها في المجتمع والتي يمكن أن أساهم في حلّها؟ ما هو دوري في ظل الواقع المزري لبلدي؟ هل أنا أرضى بأن أُسخّر خبراتي وطاقاتي لشركات أجنبية لا تحتاجُني، بينما لا ألبّي نداء الوطن؟